بطاقة الإتصال




نهدف من خلل هذه الدروس إلى تمكين طلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق تخصّص قانون خاص من التعرّف على أهم العقود الخاصّة التي تناولها المشرع الجزائري في القانون المدني الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، من خلال دراسة أحكام كل من عقد البيع وأحكام عقد الإيجار (الكراء) بإعتبارهما أهمّ التصرفات القانونية التي تقوم عليها المعاملت المالية.
وسيكون الطالب مُلما بأهداف المقياس بناء على مستويات بلوم المعرفية :
1. مستوى المعرفة والتذكر
- تحفيز الطالب على استعادة مكتسباته القبلية التي تحصل عليها سابقا من خلال الاختبارات الأولية
2. مستوى الفهم والاستعاب
- تعرف الطالب على مختلف النظريات منذ ظهُور عقد البيع وكذا عقد الإيجار
3. مستوى التحليل
- قدرة الطالب على التمييز والمقارنة بين عقد البيع وأهم الفروق فيما بينه وبين عقد الإيجار
- بالاضافة الى ذلك قدرة الطالب على تحرير هذه العقود المدنيو والتجارية.
4. مستوى التقويم
- القدرة على اجتياز الاختبارات النهائية

لكـي يسـتطيع الطالـب اسـتيعاب هـذا المقيـاس بسـهولة
يجب أن يكُون على دراية بمضمون مقياس المدخل إلى العلوم القانونية (مصادر
الإلتزام، أحكام الإلتزام)، وكذلك بالنسبة لمقياس القانون المدني لاسيما ما تعلق منها بأحكام العقود.

درج الفقه على تقسيم العقود المدنية أو تلك التي تخضع للقانون الخاص إلى عقود مسماة وأخرى غير مسماة، ولم يقصد المشرّع بتنظيم هذه العقود المسماة عدم العتراف بغيرها من العقود غير المسماة.
يقصدُ بالعقود المسماة في فقه القانون مجموعة من العقود كثيرة التداول في الحياة العملية، مثل: عقد البيع، عقد الهبة، عقد الشركة ( مدنية كانت أو التجارية )، عقد المقاولة، عقد الوكالة ... إلخ، وقد نظّمها المشرّع الجزائري تنظيما مفصّل نظرا لهميتها القتصادية والجتماعية وكثرة التعامل بهذا النوع من العقود في الحياة اليومية، وفي المقابل فإن العقود غير المسماة هي التي لم يتعرّض لها المشرّع الجزائري بالتقنين تاركا المجال للمتعاقدين بأن يبرمُوا عقودا حسب حاجاتهم لتبقى الحرية متاحة لطرفي العقد، وتبقى قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " سارية المفعول في إطار إحترام مبادئ النظام العام والداب العامة.
وتكييف العقد واععتباره عقدا من العقود المسماة أو إعتباره عقدا غير مُسمى ل يخضع لمجرّد اللفظ الذي يستعمله المتعاقدان أو التسمية التي يُتفق عليها المنشؤون للعقد فقد تكون خاطئة، خاصة إذا ما تبيّن أنهما إتفقا على عقد غير العقد الذي سميّاه " فل عبرة باللفاظ والمباني وإنما العبرة بالمقاصد والمعاني "، فقد يكون المتعاقدان مخطئين في التكييف القانوني للعقد الذي يبرمانه، وقد يتعمد المتعاقدان إخفاء العقد الحقيقي تحت إسم العقد الظاهر كالهبة أو الوصية التي ترد في صورة عقد بيع وهذا يحدث كثيرا لسباب عديدة ومختلفة.
هذا، وقد يكون العقد بسيطا يتضمن عقدا واحدا كالبيع واليجار، وقد يشتمل على أكثر من عقد في عقد واحد ويسمى في هذه الحالة عقدا مركبا أو مُختلطا كما في العقد المبرم بين صاحب الفندق والزبون فهو عقد يجمع بين عقد اليجار والبيع والخدمات في آن واحد.
تبعا للبرنامج المسّطر في ميدان التكوين، ستقتصر دراستنا في هذا الطار على أهم عقدين حسب التقسيم التي:
المحور الأول: عقد البيع
المحور الثاني: عقد الإيجار
عرّف المشرع الجزائري عقد البيع من خلال نص المادة رقم 351 من القانون المدني الجزائريي مركزا على بيان أركانه من أطراف، محل ودُون سبب، بحيث نصت على أنّ:" البيع عقد يلتزم بمُقتضاه البائع أن ينقل إلى المشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي "، وبهذا يكُون المشرّع الجزائري قد عرّف عقد البيع بتبيان آثاره وهو نفس التعريف الذي أقرّه الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا، بالرغم من أن بعضًا من الفقه ذهب إلى إنتقاد هذا التعريف على أساس أن الأصل في التعريف تبيان عناصر الشيء وخصائصه وليس بتعداد آثاره كما فعل المشرّع والقضاء الجزائريين فضلا على أن عقد البيع قد يكون لطرف المستفيد وليس بالضرورة أن يكُون دائما لمصلحة المشتري.
حسب نص المادة رقم 65 من القانون المدني الجزائري فإنه إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد و إحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الإتفاق عليها، أعتبر العقد منبرما وإذا قام خلافٌ على المسائل التي لم يتم الإتفاق عليها فإنّ المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
وبالتالي فإن المسائل التفصيلية كما سمّاها المشرع الجزائري لا تؤثر على صحة عقد البيع، ما دام أنّ طرفي العقد إتفقا على العناصر الجوهرية في هذا النوع من العقود، ومن أمثلة المسائل التفصيلية عدم الإتفاق على من يتحمّل المصاريف التي تتبع عقد البيع، أو وقت التسليم وكذا مكانه وبعض جزئيات الشيء المبيع.
يعدُ الثمن الذي يدفعه المشتري إلى البائع في مقابل نقل ملكية المبيع عنصرا جوهريا يوازي من حيث أهميته الشيء المبيع، ويعد ركنا من أركان عقد البيع به يوجد ومن دونه ينعدم العقد ونكون أمام نظام قانوني آخر، وليكون هذا الثمن صحيح لا لبد من تتوافر ثلاثة شروط:
أن يكُون الثمن مبلغًا من النُقُود: حدّدت المادة رقم 351 من القانون المدني الجزائري طبيعة الثمن الذي يجب أن يكون في شكل نقود وإلا كنا أمام عقد آخر غير عقد البيع، ولا يهم نوع العملة التي يتم التعامل بها ما دامت تؤدي دور الوسيط في المبادلات الذي يتمتع بقبولٍ عام للوفاء بالإلتزامات.
أن يكُون الثمن مُحدّدا أو قابلاً للتحديد: يتعيّن على كل من البائع والمشتري أن يتفقا على مقدار الثمن وقت إبرام عقد البيع أو أن يتفقا على تأجيل أمر تقديره فيما بعد، على أن لا يتركا مجالاً للمنازعة بهذا الشأن مستقبلا عن قصد وإلا كان عقد البيع باطلا لإنعدام أحد أهم الأركان الجوهرية فيه، ويرد صراحة تعيين الثمن في عقد البيع كأصل عام من طرف البائع والمشتري معا، لأنّه إذا ترك أمره إلى البائع فإنّه سيرفع من قيمة الثمن وإذا ترك للمشتري فسيعمل على خفضه وفقا لمصلحته فيقع البائع في بخس لقيمة الشيء، كما أنّه ليس هناك ما يمنع من أن يعيّن طرفي العقد طرفا ثالثا من إختيارهما يؤدي دور الخبير في تحديد ثمن المبيع ويكون ملزم لهما في هذه الحالة. ّ أما في الحالة التي لم يتفق فيها طرفي عقد البيع على التحديد الدقيق للمبلغ النقدي، فهذا لا يعني أن العقد باطل وإنّما أجازت ذلك المادة رقم 356 من القانون المدني بأن يقتصر تقدير ثمن المبيع على بيان ّ الأسس التي يُحدّد بمقتضاها فيما بعد والتي يمكن أن تكون حسب سعر سوق مكان التسليم، أو سعر السوق الذي يقضي فيه العرف أن تكون أسعاره هي السارية، أو السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، أو بالسعر القانوني إذا تعلق الأمر بشيء حدّد لهُ القانون سعرا محدّدا ، وتنص المادة رقم 5 فقرة أولى من الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم المتعلق بقانُون المنافسة الجزائري :" ... يُمكن أن ّ تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم ".
أن يكُون الثمن جدّيا: لم يشترط القانون بالضرُورة أن تتناسب قيمة الشيء المبيع مع ما يقابلها من ثمن نقدي، لكن هذا لا يعني أن يكون بدل المبيع ثمنا تافها أو أن يكون فيه مغالة فيكون فاحشا ما يوحي بسوء نيّة أحد الطرفين مما يؤدي معه إلى طلب إبطال عقد البيع أو فسخه بحسب الحالة. ضمن هذا الإطار يجبُ أن يكٌون الثمن حقيْقيًا لا صُوريًا: المقصود بالثمن الصوري هو الثمن الذي يتفق من خلاله البائع والمشتري من أجل إتمام العقد في غير مظهره الحقيقي، على أن يلتزم المشتري بثمن أقل أو أكثر مما هو عليه في حقيقة الأمر أو أن لا يلتزم به أصلا ويبرّأ من الوفاء به، بالإضافة إلى ضرورة أن يكُون الثمن ليس تافهًا والمقصُود منه هو مبلغ من النقود يصل حد التفاهة في عدم تناسبه مع قيمة الشيء المبيع، ما يبعث ّ للإعتقاد على أن البائع لم يتعاقد على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل فعليًا، وفي هذه الحالة يكون عقد البيع باطلا بُطلانا مطلقا لتخلف ركن الثمن النقدي، فقيمة هذه الأخيرة التي يدفعها المشتري لا تتناسب والقيمة الحقيقية للشيء المبيع وتعد مُنعدمة كأنها غير موجودة. أمّا الثمن البخس فهو الثمن الذي يقل كثيرا عن قيمة المبيع، ولكنّ له لا ينزل إلى حد الثمن التافه الذي لا يُعتد به ولا يهم البائع الحصول عليه، فالثمن البخس خلافا على الثمن الصوري أو الثمن التافه ثمن جدي كان الحصُول عليه هو الباعث الذي دفع بالبائع على الإلتزام بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري، وهو لذلك يكفي لإبرام عقد البيع . وبالتالي، فإن ّ الثمن الجدّي هو كل ثمن ليس تافه ولا صُوري، وعليه فإذا قل الثمن عن قيمة المبيع دون الوصول إلى درجة التفاهة فالبيع يكُون صحيحا طالما ليست هناك قاعدة تقضي بأن يكون مساوي لقيمة المبيع.
تنص المادة رقم 97 من الأمر رقم 58-75 المعدل والمتمم المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق بالقانون المدني الجزائري:" إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقدُ باطلا" وتليها المادة رقم 98 من نفس الأمر:" كل إلتزام مفترض أن له سبب مشرُوعا، ما لم يقُم الدليل على غير ذلك. ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام
الدليل على صورية السبب على من يدعي أن الإلتزام سببًا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه".
ّ يعتبر ركن السبب في عقد البيع مجرد تطبيق للقواعد العامة مثله في ذلك مثل باقي العقود ، وعليه نرجع
إلى أحكام النظرية العامة للإلتزام من خلال نصي المادتين 97 و 98 من القانون المدني الجزائري وتطبيق
النصين يعني أنّه يجب أن يكون السبب موجودا، وسبب التزام كل متعاقد هو محل التزام المتعاقد الآخر،
فالبائع يجد سبب التزامه نقل الملكية في قبضه للثمن والمشتري يجد سبب التزامه بدفع الثمن في
تملكه للمبيع ولهذا يعتبر الكثير من فقهاء القانُون أنّ المحل في عقد البيع وسببه وجهان لعملة واحدة.
ويشترط أن يكون السبب مشرُوعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامّة وإلا كان باطل بطلنا مطلقا لا يجُوزُ معه تصحيح العقد.
بعد أن يستوفي عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري جميع أركانه وشروطه وتكون صحيحة وفق ما يقتضيه القانون، يترتب على ذلك آثار على الطرفين فيتحمّل كلٌ من البائع والمشتري إلتزامات متقابلة تمثّل حقا للطرف الآخر وفقا لما ينص عليه عقد البيع.
يتعيّن على البائع بموجب عقد البيع أنْ ينقل ملكية الشيء/ الحق المالي إلى المشتري، وأن يكون هذا الشيء قابلُ للإستعمال مع ضمان عدم التعرّض للمشتري أو من هو في حكمه.
تختلف كيفيات نقل الملكية بحسب طبيعة الشيء محل عقد البيع لذا نفرّق بين المنقول والعقار بحسب الحالة.
بالنسبة للمنقُول: الأصل في بيع المنقول تنتقل فيه ملكية الشيء بمجرد التعاقد من البائع إلى المشتري وتتحقق عادة بنقل حيازتها عن طريق التسليم من دون الخضوع إلى إجراءات أخرى كأصل عام، وإن كان ليس هناك ما يمنع من أن يتم نقل الملكية في وقت لاحق متفق عليه تبعا إلى عدم تعلق هذا الموضوع بالنظام العام طبقا لنص المادة رقم 363 فقرة أولى من القانون المدني، أو إذا كان محل المبيع شيئا يتحقّق في المستقبل فيتعذر نقل ملكيته لمجرد إبرام العقد، أمّا إذا كان الشيئ المبيع محدّدا بنوعه فيتعيّن على البائع فرزه قبل نقل ملكيته إلى المشتري .
بالنسبة للعقار: نظرًا لخصٌوصية العقار فإنّ إنتقال الملكية فيه يتم بإفراغه في شكل رسمي وفق ما نصت عليه المادة رقم 324 مُكرّر 1 من القانُون المدني الجزائرِي، وتسجيله لدى مصلحة التسجيل بالمحافظة العقارية طبقا لنص المادة رقم 793 من القانون المدني:" لا تنتقلُ الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار ... إلا إذا رُوعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري "، وهو الحكم الذي ذهبت إليه المادة رقم 15 من الأمر رقم 75-74 المُؤرخ في 12 نُوفمبر 1975 المُتضمن إ م أ ع و ت س ع.
فيكونُ تسليم العقار بإخلائه ومنح البائع للمشتري مفاتيح ومستندات ملكية العقار، أمّا بالنسبة للمنقول فيتحقّق التسليم فيه بالمناولة أو بنقله إلى المكان الذي حدّده المشتري، كما يتحقق أيضا بتسليم المستندات غير أنّه في هذه الحالة إذا تصرّف فيه البائع مرة أخرى وكان المبيع بضاعة تكون الأفضلية لمن إستلم الشيء ماديا في حال كان المشتري الأول والثاني حسن النيّة .
بالنسبة لزمن التسليم فالصل فيه أن يتم فور إبرام عقد البيع ، أمّا عن مكان التسليم فيكون في موطن البائع فيما عدا المبيع المعيّن بالذات فيكون في المكان الذي كان يوجد فيه وقت إبرام العقد ، وحسب المادة رقم 368 من القانون المدني إذا كان المبيع واجب التصدير فيكون التسليم فيه في مكان الوصول، كل هذا ما لم يُتفق على خلف ذلك.
أمّا عن نفقات التسليم فيتحمّلها البائع بصفته المدين بهذا الإلتزام طبقا لنص المادة رقم 283 من القانون المدني الجزائري، وتحمّل المادة رقم 369 من القانون المدني البائع مسؤولية المحافظة على المبيع حتى يحصل التسليم الفعلي ما لم يثبت إهمال المشتري بعدم تسلمه في المكان والزمان المتفق عليها.
وينقسم هذا النوع من الضمان إلى قسمين هما:
إلتزام البائع بعدم التعرّض والإستحقاق: تنص المادة رقم 371 من القانون المدني الجزائري:" يضمن البائع عدم التعرّض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان هذا التعرّض من فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري. ويكون للبائع مطالَبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آلت إليه هذا الحق من البائع نفسه "، يتعيّن على البائع ضمان تمكين المشتري من حيازة المبيع والإنتفاع به، كما يلتزم بتعويضه في حال وقع الإستحقاق من الغير، كما يلتزم البائع بتمكين المشتري من الإنتفاع بالمبيع وبضمان عدم التعرّض الشخصي أو الصادر من الغير وهو إلتزام أبدي، وهذا زيادة على المبدأ القائل:" من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرّض. ويُعتبر هذا الحق من النظام العام الذي لاَ يجوز الإتفاق على مخالفته، وهو الحكم الذي نصت عليه المادة رقم 378 من القانون المدني:" يبقى البائعُ مسؤولاً عن نزع يد ينشأ عن فعله ولو وقع الإتفاق على عدم الضمان ويقع باطلاً كل إتفاق يقضي بغير ذلك "، غير أنّهُ إذا وقع التعرّض فعلا ولم يطالب المشتري بحقه في الضمان فيمكن البائع أو المتعدي تملك الشيء بطريق التقادم المكسب المقدّر ب 15 سنة كاملة .
الإلتزام بضمان العيُوب الخفيّة للمبيع: تنص المادة رقم 379 من القانُون المدني الجزائري:" يكُون البائع ملزما للضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهّد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الإنتفاع به بحسب الغاية المقصُودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو إستعماله. فيكون البائع ضامنا لهذه العيُوب ولو لم يكن عالما بوجُودها.
غير أنّ البائع لا يكون ضامنا للعيُوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع أو كان في إستطاعته أن يطّلع عليها لو أنّه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلّا إذا أثبت المُشتري أن البائع أكّد له خلو المبيع من تلك العيُوب أو أنّه أخفاها غشّا عنهُ ". يقصدُ بالعيب الخفي النقص الموجُود في المبيع الذي يظهر عند فحصه والكشف عليه والذي يمنع المشتري من إستعماله والإنتفاع به، ما يؤدي إلى الإنتقاص من منفعته، ويبقى للمشتري الحق في رفع دعوى الضمان في أجل سنة من يوم التسليم ما لم يتفق بغير ذلك، بإستثناء الحالة التي يكون فيها البائع قد مارس التدليس فيمدّد أجل التقادم إلى ( 15 ) سنة طبقا لنص المادة رقم 827 من القانون المدني، وحسب المادة 386 فبالنسبة للمبيع الذي يصلح للعمل لمدة معلومة يتعيّن على المشتري في حال وجود الخلل أن يبلّغ البائع في أجل شهر من إكتشاف العيب وأن يرفع دعواه في أجل 6 أشهر من يوم العلم.
تبعًا لكون عقد البيع ملزمٌ لجانبين، يتعيّن على المشتري في هذا النوع من العقود بإعتباره طرف ثاني في العلاقة التعاقدية إلتزامات متقابلة حتى ينبرم عقد البيع صحيحا منتجا لآثاره القانونية.
الإلتزام بآداء الثمن النقدِي: نصت المادة 351 من الأمر 75-58 المُعدّل والمتمم المتعلق بالقانُون المدني الجزائري على أنّ:" البيْعُ عقد يلتزم بمُقتضاه البائع أن ينقل إلى المشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي ". وهو الإلتزام الأساسي الذي يقع على عاتق الطرف المشتري في عقد البيع، فمن دون مبلغ نقدي لا نكُون
أمام عقد بيع وإنما أمام عقد آخر مسمى أوغير مسمّى حتى وإن إتفق الطرفان على تسميته بعقد البيع، والأصل أن يقوم المشتري نفسهُ بآداء الثمن النقدي إلى البائع ولكن لا يُوجد مانع من أن يلتزم شخص آخر غير المشتري بآدائه كما في حالة الوفاء الحاصل من حائز العقار المرهُون الذي يقُوم بالوفاء للدائن المرتهن حتى يطهّر العقار من الرهن أو حالة الوفاء الحاصل من طرف الأب.
ويؤدي المشتري قيمة المبلغ النقدي المُتفق عليها إلى البائع وفق الكيفيات والآجال المتفق عليها في العقد، ويجوز أن يكون الثمن زائدا أو ناقصا بالتناسب مع زيادة المبيع الذي لا يمكن تجزأته إذا كانت الزيادة أو التخفيض من الثمن طفيفة، عملاً بنص المادة رقم 365 فقرة 2 من القانُون المدني:" ... إذا تبيّن أنّ قدر الشيء المبيع يزيد على ما ذُكر بالعقد، وكان الثمن مقدّرا بحسب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتقسيم أن يدفع ثمنا زائدا إلا إذا كانت الزيادة فاحشة ففي هذه الحالة يجوز لهُ أن يطلب
فسخ العقد كل هذا ما لم يُوجد إتفاق يخالفه "، كما يجُوز للبائع أن يطلب تكملة الثمن في حدود أربعة أخماس قيمة محل عقد البيع الذي يجب أن يكون عقارا بيع بغبن يزيد عن خمس الثمن الحقيقي وقت البيع، ويتقادم هذا النوع من العقود بمرور ثلاث سنوات من يوم إبرام عقد البيع .
وحسب المادة رقم 366 من نفس القانُون فإن الحق في طلب إنقاص الثمن أو زيادته وكذا طلب فسخ العقد تسقط بمرُور سنة واحدة من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع.
مع مُلاحظة أنّ إنخفاض العملة أو إرتفاعها لا يغيّر من قيمة مبلغ النقود عن آدائه، عمل بنص المادة رقم 95 من القانُون المدني:" إذا كان محل الإلتزام نقودًا إلتزم المدين بقدر عددها المذكُور في العقد دون أن يكون لإرتفاع قيمة هذه النقود أو لنخفاضها وقت الوفاء أي تأثير ".
أمّا عن زمان ومكان الوفاء بثمن المبيع فيكُون وقت ومكان تسليم المبيع ما لم يُوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك بحسب ما نصت عليه المادتين 387 و 388 من القانُون المدني، فيما عدا إذا كان دفع الثمن مؤجل ولم يحصل الإتفاق بمكان الوفاء فيكُون في موطن المشتري وقت الإستحقاق.
وفي حال أخّل المشتري بهذا الإلتزام جاز للبائع حق مسك المبيع إلى أن يستوفي الثمن أو أنْ يطلب فسخ العقد مع إمكانية طلب التعويض بقدر الضرر طبقا لنص المادة رقم 390 من القانُون المدني:" إذا كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن يُمسك المبيع إلى أنْ يقبض الثمن المستحق ولو قدّم لهُ المشتري رهنا أو كفالة هذا ما لم يمنحهُ البائع أجل بعد إنعقاد البيع. يجُوزُ كذلك للبائع أن يُمسك المبيع ولو لم يحِل الأجل المتفق عليه لدفع
الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل ع طبقًا لمقتضيات نص المادة رقم 212
قانُون مدني، من خلال نص هذه المادة يتضحُ أن المشرّع الجزائري أعطى للبائع
الحق في حبس المبيع أي الحق في الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه بالتسليم،
فيحبسهُ إلى أن يستوفي الثمن سواء كانت الملكية قد إنتقلت إلى المشتري أو
مازالت لم تنتقل بعد.
إلتزَام المُشتري بتسلُّم المبيع: ومعناه أنّه يجب على المشتري أن يضع يده على المبيع وأن يحُوزه حيازة حقيقية، وحسب المادة رقم 394 قانُون المدني:" إذا لمْ يعيّن الإتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسّلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمهُ بدُون تأخير بإستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم ".
ويبقى على المشتري الإلتزام بتحمّل نفقات التسلّم مالم يُوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك وفقا لنص المادة رقم 395 من القانُون المدني.
إلتزام المشتري بدفع تكاليف البيع: يتحمّل المشتري نفقات المبيع طبقا لنص المادة رقم 393 من القانٌون المدني:" نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك ".
عرّفه المشرّع الجزائري في نص المادة رقم 467 من القانلون المدني:" الإيجار عقد يمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع بشيء لمدة محدّدة مقابل بدل إيجار معلوم.
يجوز أن يحدّد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر ".
الأهداف الخاصّة بهذا القسم والتِي تتمثل في:
- التعريف بعقد اليجار،
- توضيح الأركان التي يقُوم عليها هذا النوع من العقُود وكذا لشُرُوط صحته،
- ذكر آثار عقد الإيجار كما وردت في نُصٌوص القانون المدني الجزائري مع التطرق لإلتزامات كل طرف من المتعاقدين وكذلك لحُقُوقه.
يسري على عقد الإيجار نفس الأحكام المتعلقة بعقد البيع وبصفة عامة كل العقود فيما يتعلق منها بأركان العقد من تراضي، محل وسبب.
يمكن لمالك الشيء أو المنتفع به أو ممن يملك حق الإدارة أن تكون له صفة المؤجر، ويبقى الفارق قدرة المؤجر عندما لا تكون له صفة المالك فإنّه لا يمكن أن يعقد إيجارا تزيد مدته عن 3 سنوات تبعا لنص المادة رقم 468 من القانٌون المدني:" لا يجوز لمن لا يملك إلّا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث ( 3) سنوات ما لم ل يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
إذا عٌقد الإيجار لمدة أطول من ذلك تخفّض المدة إلى ثلث ( 3) سنوات".
أمّا المستأجر فيمكن أن يكون أي شخص قادر على الوفاء بالإلتزامات، ويتعيّن في شخص المؤجر والمستأجر أن يكون متمتعا بأهلية التعاقد غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية ولا بعيوب الإرادة.
يختلف محل عقد الإيجار بالنظر إلى صفة الطرف المتعاقد، فمحل العقد من جهة المؤجر هو العين المؤجرة ومن جهة المستأجر هي الأجرة أو بدل الإيجار.
بالإضافة لوجوب توفر الشروط العامّة لمحل العقود بأن يكون محل العقد موجودا أو قابل للوجود ومعيّنا أو قابلًا للتعيين، يشترط في عقد الإيجار زيادة على ذلك أن يكُون الشيء المؤجر غير قابل للإستهلاك وإلّا عجز المستأجر عن رد الشيء المستأجر وكذلك لم يتحقق الغرض من الإيجار وهو تمكين المستأجر من الإنتفاع مدة من الزمن .
وهي المقابل الذي يلتزم به المستأجر في مواجهة المؤجر في مقابل إنتفاعه بالعين المؤجرة والذي قدْ يكُون في شكل نقود، آداء عمل أو أي شيء آخر، ويشترط فيها أيضا وقت التعاقد أن تكٌون موجودة أو قابلة للوجود، معيّنة أو قابلة للتعيين، وأن لا تكون صورية أو تافهة.
ويخضع لأحكام النظرية العامّة للعقود بأن يكون السبب مشروعًا غير مخالف للنظام العام والآداب العامّة كأن يكون الدافع من إبرام عقد الإيجار إستعمال العين المؤجرة لبيع الممنوعات كالمخدرات أو لمزاولة القمار ... إلخ، كما نشير إلى أنّ النظام العام والآداب العامّة تختلف من بلد إلى آخر بحسب العقيدة الإجتماعية والسياسة للبلد.
ويترتب عن تخلف السبب أو إذا كان السبب غير مشرُوع بطلان عقد اليجار بما لا يجوز معه تصحيح عقد الإيجار.
تنص المادة رقم 467 مكرّر من الأمر رقم 75- 58 المعدّل والمتمم المُتعلق بالقانون المدني الجزائري:" ينعقد الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وإلا كان باطلاً ".
على خلاف عقد البيع لا تكفي الرضائية لإبرام عقد الإيجار في القانون الجزائري حرصًا من المشرّع للحفاظ على المعاملاَت لاسيما التجارية منها، وإنّما يجب أن ينعقد عقد الإيجار مكتوبا وإلا كان باطلا، ولم يشترط المشرّع ضرورة أن تكون هذه الكتابة رسمية فيما عدا ما تعلق منها بالعقار أو فيما تعلق ببعض التصرّفات الأخرى التي يشترط فيها القانٌون وجوب أن تكون غب شكل قالب رسمي، والكتابة المقصُودة هنا مطلوبة كشرط للإنعقاد حتى يكون عقد الإيجار صحيحا منتجا للآثاره وليس لمجرّد الإثبات.
بما أن عقد الإيجار من العقود الملزمة لجانبين، فهذا يعني أن هذا العقد يرتب إلتزامات متقابلة لكلا الطرفين، وكل إلتزام يعد حقا للطرف الآخر.
يجب على المؤجر في إطار عقد الإيجار تحت طائلة فسخ العقد أن يلتزم:
يقصدٌ بالتسليم وضع العين المؤجرة تحت تصرّف المستأجر، وهو أوّل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد مثلُهُ مثل البائع، إذْ على المؤجر أن ينقل إلى المستأجر الحيازة المادية للعين المؤجرة وفق ما أتفق عليه وفي الميعاد المحدّد، وهذا يعني أن المؤجر ينفذ إلتزامهُ هذا إذا وضع العين المؤجرة تحت تصرّف المستأجر وأخطره بذلك، حتى ولو لم يتسلمها المستأجر تسلما ماديًا ما دام المؤجّر مكنه من التسليم، وقدْ يكون التسليم رمزيا وذلك بأن يسلّم المؤجر للمستأجر مفاتيح العين المؤجرة أو حكميا كما إذا كان المستأجر هو المالك السابق للعين المؤجرة وتصرّف فيها وبقي محتفظا بحيازتها .
بالإضافة إلى تسليم العين المؤجرة يجب على المؤجر أن يمنحها للمستأجر في حالة تكون صالحة للإستعمال وأن يداوم على صيانة العين المؤجرة والمحافظة عليها طوال مدة الإيجار المتفق عليها في عقد الإيجار، تنص المادة رقم 479 من القانُون المدني:" يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم.
ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرُورية أثناء مدة الإيجار، دون الترميمات الخاصّة بالمستأجر.
ويتعيّن عليه أن يقُوم لاسيما بالأعمال اللازمة للسطح من تجصيص وأعمال تنظيف الآبار وكما يتعيّن عليه صيانة وتفريغ المراحيض وقنوات تصريف المياه.
يتحمّل المؤجّر الرُسُوم والضرائب وغيرها من التكاليف المثقلة للعين المؤجرة ".
فالمؤجر إذن لا يلتزم إلّا بالقيام بما لا يعتبر من أعمال الإصلاح أو الترميم دون أعمال التجديد، فالترميم خلل يعتري الشيء، أمّا التجديد فهو أن لا يعاد الشيء إلى أصله بعد زواله.
ونفرّق هنا بين نوعين من الضمان القانُوني وهما تباعًا:
يلتزمُ المؤجر قانونا بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة إنتفاعا هادئا بعيدا عن كل تعرّض سواء كان هذا الأخير تعرّضا شخصيا وبالتالي فهو الإمتناع عن القيام بعمل، أو كان من طرف الغير وفي هذه الحالة يكون القيام بعمل ولا يهم سبب هذا التعرّض ومدى مشروعيته، وقد إحتوت المادة رقم 483 من القانُون المدني هذا الحق بنصها:" على المؤجر أن يمتنع عن كل تعرض يحُول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز لهُ أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير ينقص من هذا الإنتفاع.
ولا يقتصرُ ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعيه، بل يمتد إلى كل ضرر أو تعرّض قانُوني صادر عن مستأجر آخر أو أيّ شخص تلقى الحق عن المؤجر ".
ثانيا: ضمان العيُوب الخفيّة
نصّت على هذا الإلتزام المادة رقم 488 من القانُون المدني الجزائري:" يضمن المؤجر للمستأجر بإستثناء العُيُوب التي جرى العرف على التسامح فيها، كل ما لا يُوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحُولُ دون إستعمالها أو تنقص من هذا الإستعمال نقصًا محسُوسًا، ما لم يوجد إتفاق على خلافِ ذلك.
ويكُون كذلك مسؤُولاً عن الصفات التي تعهّد بها صراحة.
غير أنّ المؤجّر لاَ يضمن العُيُوب التي أعلم بها المستأجر أو كان يعلم بها هذا الأخير وقت التعاقد ".
وبهذا يكون ضمان العُيُوب الخفية إلتزامٌ في مواجهة المستأجر لفائدة المؤجر تحت طائلة الجزاءات القانونية في حالِ الإخلال بهذا الإلتزام القانُوني.
ورد تنظيمها في المواد من 491 إلى 503 من القانٌون المدني الجزائري وتتلخص فيما يلي:
المدين بالأجرة هو المستأجر، وإذا تعدّد المستأجرون أو مات المستأجر وخلفه ورثته إلتزموا بدفع بدل الأجرة كُلٌ بنسبة نصيبه، حيث ينقسم دينها عليهم وبلا تضامن بينهم، أمّا اأجرة التي أستحقت قبل الوفاة فهي دين على التركة ولا ينقسم دينها على الورثة ويجوز الوفاء بالأجرة عن طريق الغير والذي لهُ أن يرجع بها بعد ذلك على المستأجر.
تُدفع الأجرة وفق ما تمّ الإتفاق عليه في عقد الإيجار دفعة واحدة أو في أقساط وفي حال عدم الإتفاق يسري عليها العُرف الجاري، وإن تعذر ذلك تدفع الأجرة بعد إستيفاء المنفعة، أمّا عن مكان الوفاء بالأجرة فنصت المادة 498 فقرة 2 من القانُون المدني:" ويكُون دفع بدل الإيجار في موطن المُستأجر ما لم يكن إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ".
وللمؤجر بإعتباره الدائن في هذه العلاَقة في حالة عدم آداء المدين بإلتزامه حق حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وله عليها حق إمتياز عليها في حدود أجرة سنتين، وتسقط الأجرة بإعتبارها دين بمُرُور خمس (05)سنوات من تاريخ الإستحقاق .
يجب على المستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة وأن يبذل في ذلك عناية الرجل العادي، وهو مسؤولُ عن ما يلحق بها من فساد أو ضرر نتيجة الإستعمال غير السليم.
ويختلف ما يجب على المستأجر القيام به في سبيل المحافظة على العين المؤجرة ورعايتها بإختلاف الظروف والأحوال، وقاضي الموضوع هو الذي يقدّر ذلك ويحدّد العٌرف المحلي وكذلك طبيعة الشيء المؤجر قدر ونوعية العناية المطلوبة للحفاظ على العين المؤجرة ورعايتها، ويكون المستأجر مسؤُولا عن الحريق الذي يلتهم العين المؤجرة مالم يثبت عدم مسؤوليته.
وعادة ما يتم النص على الغرض من الإستئجار في عقد الإيجار، ويجوز للمستأجر أن يغيّر من نوع إستعمال العين المؤجرة بموافقة المؤجر سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية، والأكثرُ من هذا يتعيّن على المستأجر في بعض الحالات أن لا يترك محل الإيجار دٌون إستعمال إذا كان هذا الترك سيضر بها بسبب عدم النظافة أو التهوية أو إعتداء الغير عليها.
كما يلتزم المؤجر في إطار عقد الإيجار يخول المستفيد منه فقط حق الإستعمال لا غير، تضمنت هذه الأحكام المادة رقم 492 من القانون المدني حين نصت:" لا يجُوز للمستأجر أنْ يحدث بالعين المؤجرة أيّ تغيّير بدون إذن مكتوب من المؤجر.
إذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة يلزم بإرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها ويعوّض الضرّر عند الإقتضاء.
وإذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر تغييرات في العين المؤجرة زادت قيمتها، وجب على المؤجر عند إنتهاء الإيجار أن يرُد للمستأجر المصاريف التي أنفقها أو قيمة ما زاد في العين المؤجرة ما لم يُوجد إتفاقٌ يقضي بخلاَف ذلك ".
ثالثًا: الإلتزامُ برد العين المُؤجرة
يلتزم المؤجر بمُوجب عقد الإيجار بإرجاع العين المؤجرة بملحقاتها إلى المؤجر في الحالة التي إستلمها في المكان المذكُور في العقد، ويحصل هذا الرد على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء محل عقد الإيجار فإذا كان شقة مَثَلاً فيتم رده بطريق إخلائه وتسليم المفاتيح للمؤجر.
أمّا عن مصاريف الرّد فتقع على المستأجر بإعتباره المدين في هذه العلاَقة ما لم يتفق بخلاف ذلك أو يوجد عُرف يقضي بغير ذلك.
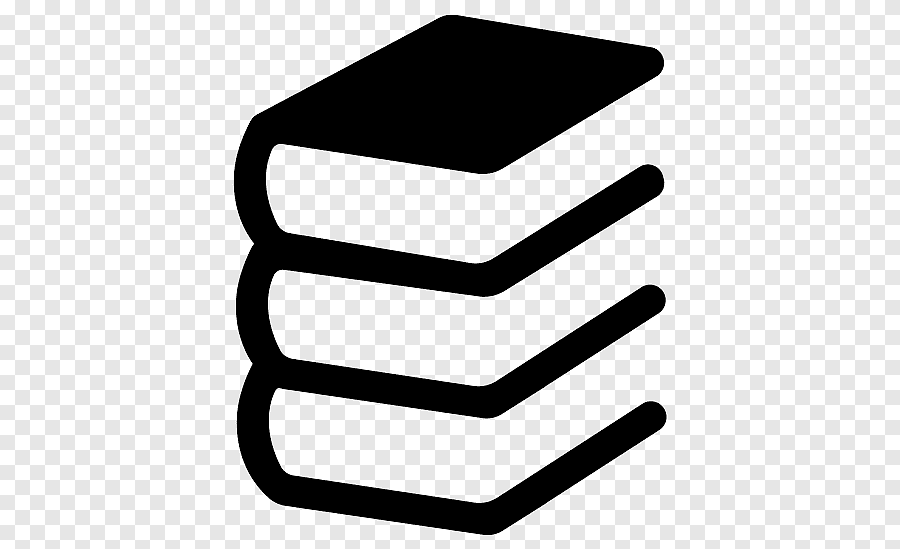
أولا: النصُوص التشريعية
ثانيًا: الكتب
ثالثا: المواقع الإلكترٌونية
تكلم بإيجاز عن آثار عقد البيع.